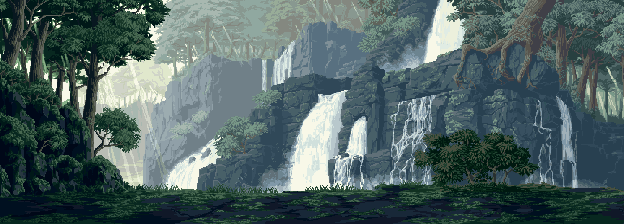وجاء الشرطي
فسأله الرجل : ايش المشكله؟
الشرطي : انت كنت مسرع فوق الـ180 كيلو في الساعة وهذا الطريق سرعته القصوى 60 كيلو في الساعة ، عشان كذا أنا حديك مخالفه
الرجل: لامعليش أنا كنت متعدي ال60 بشويه .
الزوجة : انت كنت ماشي على الأقل 160
الزوج نظر لزوجته نظره حقد
الشرطي: اعطيك مخالفه كمان عشان الضوء الخلفي مكسور
الرجل: مكسور؟؟ أنا ما كنت اعرف انه مكسور
الزوجه : ايوه انت كنت عارف عن اللمبه انها مكسوره من كم اسبوع ،
واعطاها الزوج نظرة حقد ثانيه
الشرطي: واعطيك ورقه انذار عن عدم ربط حزام الامان
الرجل: ايش أنا فكيته لما وقفت السيارة وجيت عندنا
الزوجه: لالالا انت عمرك ما ربطت حزام الامان
التفت الزوج الى زوجته وصـرخ عليها : انتي متعرفي تسكتي ابدا ؟
سأل الشرطي الزوجه : لو سمحتي ..... هو دايما يصرخ عليك كذا ؟
قالت الزوجه: لا بس لما يكون سكران
قال الشرطي : سكران !!!!!
الرجل : لالالا تصدقها
قالت السيدة : لا تسمع كلامه , أحنا لاقينا قارورة الويسكي في السيارة لما سرقناها
قال الشرطي: يعني السيارة مسروقه
قال الرجل : لا تسمع لها ، ويلتفت الى الزوجة ويقول لها ....لا تخليني اطلقك
قال الشرطي : هل هو دايما يهددك بالطلاق
قالت السيدة : خليه الاول يتجوزني وبعدين يحلف بالطلاق