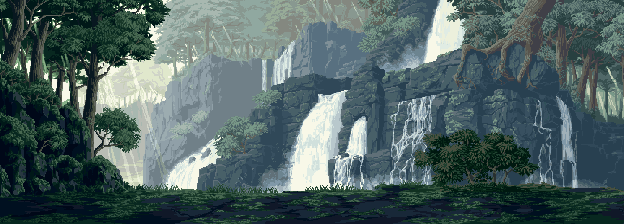واضح أن الفلسطينيين ينزلقون من الموقف الأفضل إلى الأسوأ، ثم إلى الذي يفوقه سوءا، وهكذا تتدنى وتتواضع مطالب الفلسطينيين من قرار التقسيم الذي كان سيمنحهم نصف فلسطين؛ إلى أوسلو و«الأرض مقابل السلام» في عهد أبو عمار، إلى «الهدنة مقابل الكهرباء» في عهد إسماعيل هنية وخالد مشعل. فالفلسطينيون يهبطون على سلم المطالب بدل أن يصعدوا من سقفها، وليس هذا في فلسطين وحدها، فالناظر إلى نتائج (النصر الإلهي) الممول بـ(الدولار الطاهر)، يعرف أن جنوب لبنان الذي كان محررا لم يعد بعد حرب تموز كذلك، فقد أصبح اليوم تحت إمرة القوات الدولية التي تسيطر عليه وتبقي السيادة اللبنانية منقوصة على الأرض اللبنانية.
اليوم هناك سؤالان مهمان وهما: لماذا يثق الشارع العربي بـ(المقاومة) التي قادته إلى انتصارات كاذبة وخفضت سقف مطالبه حتى بلغ الفتات؟ ولماذا تهزم جيوش الدول العربية الرسمية في حروبها، بينما تنجح هذه (المقاومة) في الاستمرار؟
إسرائيل مثلا، هزمت ثلاثة جيوش عربية في ستة أيام عام 1967، بينما لم تستطع أن تهزم حزب الله بالشكل الساحق الذي هزمت به تلك الجيوش مجتمعة. أميركا أيضا هزمت الجيش العراقي النظامي ولم تهزم المقاومة العراقية. السر يكمن، ليس كما ادعى بعض الغربيين، بأن دولنا هي «قبائل بأعلام» ((tribes with flags، وإنما يكمن في عدم قدرة دولنا على أن تكون لها أعلام تحترم ويؤمن بها كافة أطياف الشعب الواحد، فقسم كبير من الفلسطينيين اليوم يرفع علم حماس لا علم سلطتهم الوطنية، ومجموع كبير من اللبنانيين والعرب اليوم يرفعون علم حزب الله لا علم دولتهم. يؤكد هذا حقيقة مؤلمة وهي أننا، كعرب، غير قادرين على الانتماء لدولة حديثة، باستثناءات قليلة جدا، فنحن قوم لا نستطيع الانتماء إلى شيء أكبر من العشيرة، سواء أكانت هذه العشيرة تجمعها عصبية الدم أو الآيديولوجيا. وإلا كيف يفهم أن يصبح أقصى فضاء سياسي نسبح فيه هو فضاء إمارة حماس، أو جنوب لبنان، أو الأنبار أو البصرة.. حتى أن كثيرا ممن هاجروا منا إلى الغرب، رغم ما يتميز به بعضهم من علم، غير قادرين على الانتماء لدولهم المتبناة التي ذهبوا إليها بملء إرادتهم واستماتوا للحصول على جنسياتها، فهم إما جزء من أمة إسلامية كبرى أو جزء من حمولة في عشيرة أو قبيلة، هم لا يقدرون على الانضواء تحت مفاهيم الدولة الحديثة والمواطنة، فإما أن يحلقوا فوق الدولة أو يتسربوا من تحتها.. وليس خافيا على أحد أن العديد من أعضاء الحركات الإسلامية (المناضلة) في العالم العربي يحملون الجنسية الأميركية والبريطانية، فقط يستخدمون هذه الجوازات لتسهيل مهماتهم.
يحدث كل هذا أيضا لأن معظمنا لا لون لنا، يحب أن يسبح في درجات مختلفة من اللون الرمادي، لا يمكن له أن يكون أبيض أو أسود، هو رمادي فاتح، ورمادي غامق، ورمادي أغمق.. الخ. فهم مع «الحوار» ومع «المصالحة» وكل الكلام «إللي ملوش لازمة».. لا مواقف تتخذ في المعارك التي تحدث في مضارب عبس، فقط تمتشق الحناجر المناضلة عند التحدث عن الغير.
وصلنا لما نحن فيه، لأننا نكذب على أنفسنا ونبني استنتاجات على الوهم.. كذبنا على أنفسنا وقلنا لأجيال كاملة بأننا انتصرنا على بريطانيا وفرنسا وإسرائيل دفعة واحدة عام 1956. فلم نبن جيشا بعد هذا لأننا الأفضل ولأننا منتصرون.. عشنا نشوة النصر المتوهم من 1956 إلى 1967، ثم أفقنا على الهزيمة الكبرى.. إذن بذرة هزيمة 1967 زرعت فى كذبة نصر 1956. بنفس الطريقة يمكنك توقع هزيمة أخرى، لأننا زرعنا كثيرا من بذور الكذب يوم (النصر الإلهي). وعندما تواجه أحدهم بهذه الحقائق، يرد عليك بعبارة الشوارع المصرية: «إحنا إللي بهيظنا الفهايص»، وهي عبارة يطلقها الشباب اليوم بعد خراب كل شيء، ويعني بها المتحدث «أنا الذي جعلت الجميع يغيب عن الوعي». وبالفعل كما يبدو نحن قوم مغيبون عن الوعي، وإلا فكيف تدهور حالنا وانحدرت مطالبنا من التقسيم في عام 47، الذي كان سيمنحنا نصف فلسطين، إلى أوسلو و«الأرض مقابل السلام»، إلى ما نحن عليه اليوم من معادلة مخزية هي «الهدنة مقابل الكهرباء»؟!.
وفي سياق الحديث عن الكهرباء، أسرد نكتة فحواها أن رجلا نبه صديقه إلى أن امرأته تخرج من وراء ظهره مع «الواد سمير الكهربائي»، وتوقع الرجل أن يصبح صديقه ثورا هائجا وغضنفرا مكشرا عن أنيابه، لكنه فوجئ بأن الرجل ظل هادئا ومبتسما وقال له: «أنت رجل كذاب، سمير دا لا كهربائي ولا بيفهم في الكهربا».. وهذا بالطبع مقال مكتوب فقط «للي بيفهموا في الكهربا».