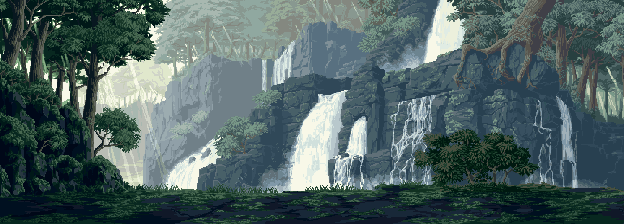What a Paulo Coelho's great approach and we all know that the Paulo Coelho's success is come from he puts the lights inside us by transferring delight.
Wednesday, March 26, 2008
Closing a cycle
What a Paulo Coelho's great approach and we all know that the Paulo Coelho's success is come from he puts the lights inside us by transferring delight.
Tuesday, March 25, 2008
قمة دمشق ولغة التلميح
غريب أن يتوقع العرب أن مبادرتهم لحل القضية الفلسطينية، ستنجح في إقناع (الخارج) الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، رغم المتغيرات والعوامل التي تحكم هذه القضية، والتي ليست في يد العرب كلها، وهم (أي العرب) في الوقت ذاته لم ينجحوا حتى الآن في مبادرة يمسكون بكل أوراق اللعب فيها تقريبا، وهي المبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية.
الجامعة العربية كانت تأمل في التوصل إلى اختيار العماد ميشيل سليمان رئيسا للبنان قبل انعقاد قمة دمشق، ولم يتحقق المأمول. فكيف للعرب إن فشلت مبادرتهم في (الداخل العربي) أن يتوقعوا نجاح مبادرتهم في (الخارج الغربي)؟ كيف لهم إذا فشلوا في إقناع قومهم وبني جلدتهم وفضائهم السياسي المحكوم بقبول مبادرة الحل في لبنان، أن ينجحوا في إقناع من يختلفون معه في الثقافة واللغة والعرق والمصالح الاستراتيجية بقبول المبادرة العربية بشأن فلسطين؟
أسباب فشل المبادرة العربية تجاه الصراع العربي الاسرائيلي ربما هي ذاتها أسباب الفشل في المبادرة العربية تجاه لبنان. وأولى هذه الأسباب هي عدم القدرة على تسمية الأسماء بمسمياتها، وثانيها التوجه بالمبادرة للعنوان الغلط، وثالثها إغفال قدرة عامل الزمن على تغيير موازين القوى. لتسويق مبادرتهم تجاه الصراع العربي الإسرائيلي ذهب العرب إلى الصين وأوروبا واليابان، ولم يتوجهوا إلى إسرائيل التي هي المستهدفة من المبادرة. بعد أن تدارك العرب الخطأ في قمة الرياض بعد أربع سنوات قرروا في خجل أن يتوجهوا لإسرائيل من خلال الدول التي قامت بسلام مع إسرائيل. إسرائيل ليست مهتمة بالدول التي تقيم سلاما معها، اسرائيل تهتم بمن ليس لها سلام معهم. ولما دخلنا في العملية بعد ست سنوات من إطلاق المبادرة، غير عامل الزمن ميزان القوة، فزادت المستوطنات وسيطرت «حماس» على غزة وانقلبت الأوضاع. ما حدث مع المبادرة الأولى تجاه إسرائيل يحدث اليوم في المبادرة الثانية تجاه لبنان.
بنفس الطريقة نتحدث عن لبنان بالتلميح لا بالتصريح، غمزا ولمزا، من دون مواجهة للحقائق القوة، ومن دون مراعاة لعامل الزمن. بداية، حالة لبنان ليست فريدة في نوعها في العالم. فلو نظرنا إلى تايوان وهي الدولة الليبرالية الرأسمالية الحرة الملتصقة بنظام مغلق إلى جوارها وهو الصين. لأدركنا أنه كان بالإمكان ان يكون لبنان تايوان العرب. النظام الصيني المغلق لم يدخل في مجابهة مع تايوان، وإنما استخدمها كرئة يتنفس منها. لبنان أيضا بانفتاحه يمثل رئة لسورية، الاختلاف بين الحالتين هو التعددية الطائفية في لبنان. ليس هناك ما يمنع من أن صيغة علاقة لبنان بسورية يمكن أن تكون أشبه بعلاقة الصين بتايوان. علاقة نجح الصينيون والتايوانيون في إدارتها، رغم أن رغبة الصين في السيطرة على تايوان وادعاءاتها بأنها جزء من الصين كانت أشد وأقوى من أي ادعاءات سورية تجاه لبنان. النقطة هنا، إن وضع لبنان ليس الحالة الاستثنائية لكي يستعصي على الحل، هناك عشرات الحالات الخاصة بعلاقة دولة صغيرة بجوار أكبر، لكن الأمور تسير بشكل أكثر تنظيما وأكثر عقلانية.
لا ضير من اعتراف عربي بأن لبنان يمثل عمقا استراتيجيا لسورية، كما أنه لا ضير من اعتراف سوري بأن لبنان، العمق الاستراتيجي السوري، ليس عمقا استراتيجيا لإيران.
لا يمكن للمبادرة العربية لحل أزمة لبنان أن تؤخذ بجدية دونما قوة تقف خلفها. القرارات الخاصة بلبنان هي قرارات دولية لا عربية، والقوة الموجودة في لبنان ممثلة في اليونيفيل هي قوة دولية لا قوة عربية. رغم كل احترامنا لسيادة لبنان على ترابه الوطني، إلا أن وضعا هشا يستلزم وجود قوة عربية تساعد هذا البلد على التعافي السياسي. غياب العرب عن لبنان دعوة لغير العرب إلى التدخل في شؤونه. في غياب العرب، رأينا الوجود الإسرائيلي من خلال الاحتلال والاجتياحات الموسمية، وكذلك رأينا النفوذ الإيراني. لا يمكن أن يكون للعرب دور في لبنان من دون وجود قوة عربية على الأرض اللبنانية. كيف يتوقع من لا جنود له على الأرض أن تكون له أدوات ترهيب أو ترغيب؟ إلا إذا صدق بأن قوة الكلام على الفضائيات وفي الجلسات الدبلوماسية أقوى من القوة الفعلية.. وهذا مناف لأبسط قوانين السياسة. لبنان اليوم مؤهل أن يكون عراقا آخر بما لذلك من تبعات على المنطقة برمتها.
عندما خرجت سورية من لبنان، ظن كثير من العرب واللبنانيين أن المجتمع اللبناني تعافى سياسيا، بحيث أنه قادر على إدارة شؤونه. كل ما رأيناه منذ خروج سورية حتى اليوم مؤشرات على أن اللبنانيين غير قادرين بعد على إدارة بلدهم. هناك المقولة المكررة بأن سورية خرجت لكنها ما زالت تلعب في الوضع الداخلي اللبناني عن طريق حلفائها، وهذا أيضا يؤكد ما ذكرته سلفا بأن النظام الداخلي ما زال ضعيفا. فأولى مؤشرات النظام الوطني المتماسك، أن تكون لديه مناعة ضد التدخلات الخارجية. إذن، حجة التدخل السوري لا تنفي مقولتي بل تؤكدها.
حتى الآن، وللمراقب من الخارج، يبدو سلوك العرب تجاه الأزمة في لبنان ساذجا. لا بد من الاعتراف بأن هناك دولتين تملكان الحل والعقد في لبنان وهما سورية وإسرائيل. دولتان جارتان لكل منهما القدرة والقوة والعتاد والجيش أن تحتل لبنان برمته إذا ما أرادت. هاتان هما الدولتان اللتان تستطيعان أن تحلا الأمر أو تعقداه في لبنان، ما عدا ذلك فكلها درجات تأثير تنتهي عند حدود الكلام. حتى إيران يظل دورها محدودا إن لم يمر خلال الأراضي السورية. سورية تستطيع تجميد «حزب الله»، رغم قوته، وكذلك إسرائيل تستطيع أن تحجم قدرات «حزب الله» رغم فشلها في الحرب الأخيرة. أما ما عدا الدور السوري والدور الإسرائيلي، فكلها أدوار جانبية بما فيها دور الولايات المتحدة. هذان هما الدوران اللذان على المبادرة العربية أن تأخذهما في عين الاعتبار.
إذن، ولكي يصل العرب إلى حل في لبنان لا بد من الحديث مع سورية مباشرة وبجدية، وظني أن قمة دمشق مناسبة لحديث جاد وصريح. للدولتين العربيتين الكبيرتين، مصر والسعودية، القدرة والأدوات في التأثير على الموقفين السوري والإسرائيلي تجاه لبنان، كما أن لديهما أيضا القدرة والأدوات على التأثير على الموقفين السوري والإسرائيلي تجاه عملية السلام. ورغم أهمية التجمع العربي في دمشق، إلا أنني ممن يفضلون قمة مصغرة تنجز شيئا ملموسا ومحددا على قمة احتفالية قد لا يسمح صخبها بحديث عملي جاد. لذا أرى أنه لا بد من قمة داخل القمة، قمة سورية مصرية سعودية.
هذه القمة المصغرة لا بد وأن تأخذ في الاعتبار بأن لبنان في طريقه لأن يصبح دولة فاشلة، إذا ما تجاهلنا عنصر الزمن، وتجاهلنا معه تغير الأوضاع على الأرض من حيث اختلال موازين القوة. ما حدث للمبادرة العربية فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي، يجب ألا يتكرر في المبادرة العربية حول الأزمة اللبنانية. لا بد من التوجه إلى العنوان الصحيح، لا بد من الحديث مع سورية بوضوح.. نسمع عن خلاف سعودي ـ سوري حول لبنان، وعن خلاف مصري ـ سوري حول لبنان، ولا نعرف طبيعة هذا الخلاف. آن أوان المصارحة، الموقف لم يعد يحتمل لغة التلمي
Friday, March 21, 2008
وجهك
| وجهك.. مثل مطلع القصيدة يسحبني.. يسحبني.. كأنني شراع ليلاً, إلى شواطيء الإيقاع يفتح لي, أفقاً من العقيق ولحظة الإبداع وجهك.. وجه مدهش ولوحة مائية ورحلة من أبدع الرحلات بين الآس.. والنعناع.. * وجهك.. هذا الدفتر المفتوح, ما أجمله حين أراه ساعة الصباح يحمل لي القهوة في بسمته وحمرة التفاح... وجهك.. يستدرجني لآخر الشعر الذي أعرفه وآخر الكلام.. وآخر الورد الدمشقي الذي أحبه وآخر الحمام... * وجهك ياسيدتي بحر من الرموز, والأسئلة الجديدة فهل أعود سالماً ؟ والريح تستفزني والموج يستفزني والعشق يستفزني ورحلتي بعيده.. وجهك ياسيدتي رسالة رائعة قد كتبت ولم تصل, بعد, إلى السماء... | |||||
Thursday, March 13, 2008
قصة
يقول الذي يروي هذه القصة: إنني بينما كنت ألعب في المنزل دققت إصبعي بمطرقة وأحسست بألم شديد، وكان الدم ينزف منه، فأخذت أبكي، وتذكرت الاستعلامات، واتجهت إلى التلفون وطلبت الاستعلامات، وأتاني صوت نسائي عبر السماعة، فقلت لها وأنا أبكي: لقد دققت إصبعي.
فسألتني: أليست والدتك في المنزل؟!
ـ لا يوجد في المنزل سواي.
ـ هل تستطيع أن تفتح الثلاجة التي لديكم؟!، فأجبتها بالإيجاب، فقالت لي: خذ قطعة ثلج صغيرة وضعها على إصبعك، فإن هذا سوف يخفف الألم.
وبعد ذلك أصبحت كلما أردت أن أعرف شيئاً، أطلب (الاستعلامات)، وأسألها في الحساب والجغرافيا، وعندما ماتت عصفورة الكناريا التي نربيها عندنا، اتصلت بها أسألها وأنا أبكي: لماذا تكون نهاية الطيور الجميلة المغرّدة التي تجلب السعادة للناس، لماذا تكون نهايتها بهذا الشكل؟!
أجابتني قائلة: ينبغي أن تتذكر يا (بول) أن هناك عوالم أخرى تغرّد فيها.
وأتذكر أن آخر يوم أمسكت فيه السماعة وسألتها أن تعلمني كيف أتهجّى وأكتب كلمة (يثبت)، لأنني بعد أن بلغت التاسعة من العمر انتقلت مع عائلتي إلى مكان آخر.
ومرّت الأعوام وكبرت وتخرجت واشتغلت، وموظفة (الاستعلامات) تلك التي علمتني وأمتعتني وزرعت في أعماقي الثقة لم تفارق خيالي أبداً.
وفي أحد الأيام وبينما كنت مسافراً بالطائرة في مهمة عمل، نزلت الطائرة (ترانزيت) في مطار البلدة القديمة التي كنا نسكن فيها، ودفعني الشوق والفضول إلى الاتصال بالاستعلامات، وإذا بها هي التي ترد عليّ، طبعاً لم تعرفني لأنني كبرت وتغير صوتي، ولكنني ما أن سألتها عن كلمة (يثبت) حتى عرفتني، وقالت لي وهي تضحك: أعتقد أن إصبعك قد شفي الآن، فقلت لها: إنك كنت تعنين لي الشيء الكثير، فأجابتني: وأنت كذلك، فلا تتصور سعادتي من اتصالك وأسئلتك، حيث إنني لم أرزق بأطفال وتخيلت أنك ابني.
ووعدتها إن عدت للبلدة مرّة أخرى لابد وأن أكلمها وأراها، فقالت: أتمنى ذلك، وأسأل عن (سالي).
وفعلاً حضرت بعد ثلاثة أشهر، وما أن اتصلت بالاستعلامات حتى أتاني صوت مختلف، وسألتها عن سالي، فقالت: هل أنت صديق؟!، نعم صديق قديم، هل أنت (بول)؟!، نعم، يؤسفني أن أبلغك أنها ماتت قبل خمسة أسابيع، حزنت جداً وانصدمت، وقبل أن أغلق السماعة، قالت لي المرأة انتظر فقد حملتني رسالة لا بد أن أوصلها لك وهي تقول: عندما تعلميه بوفاتي، اذكري له أنه ما زالت هناك عوالم أخرى نغرّد فيها، وهو سوف يعرف ما أعنيه.
وعرفت فعلاً ما تعنيه حبيبتي التي لم أرها (سالي)
Saturday, March 8, 2008
شعر لسعاد الصباح
Friday, March 7, 2008
عن العالم العربى
تقرير بيكر ـ هاملتون الذي شغل البلاد والعباد، جهد أميركي خالص ونقد ذاتي داخلي يهدف إلى لملمة جراح الأمة الأميركية المنقسمة حول حرب العراق. لن أدخل هنا في تقييم التقرير الذي يستحق مقالا خاصا، لكن ما يهمني في هذا السياق، هو متى سنقدم نقدا ذاتيا لأحوالنا؟ لدينا الكثير من المواضيع الخلافية التي لا تهدد بانقسامنا فحسب، بل بفنائنا كأمة، ومع ذلك نواجهها بدل الدراسة المتأنية التي تهدف إلى إيجاد مخرج وحل، بخطب حماسية (في لبنان وغيره) في كل منبر تظن أنها ستغطي عين الشمس بغربال!
في مواجهة أخطار تهدد بفنائنا، يتغنى أبناء هذه المنطقة بكونهم أحفاد الفراعنة، وأحفاد البابليين ، ويفخرون بأنهم أحفاد الفينيقيين والكنعانيين. يحار المرء فعلا بين ما يرى وما يسمع، بين الخيال والواقع، بين ماضي الافتخار وواقع الاحتقار. إذا كنا بالفعل أبناء هذه الحضارات، فمن أين أتى العراقيون الذين يفجرون الدور والمساجد على رؤوس أهلها، ويحرقون مدارس الاطفال في كافة أنحاء العراق؟ ومن أين أتى اللبنانيون الذين يخون بعضهم الآخر على شاشات التلفزة وفي الساحات والدارات، والمنابر العامة والخاصة، والذين خاضوا حربا أهلية مرة ولا يبدو أنهم يتورعون عن خوضها ثانية؟ يحذر كل زعيم فيهم من فتنة طائفية، وما هم إلا زعماء طوائف، الفتنة في لبنان قائمة وليست نائمة، ربما كان وجود لبنان مرهونا أصلا بالفتنة (الطائقية وغيرها). ومن أين أتى هؤلاء الفلسطينيون الذين يقف كل منهم على سلاحه بانتظار الانقضاض على الآخر؟ ومن أين أتى الجنجويد وصناع الموت في السودان؟ ومن أين أتت الجماعات الإسلامية المسلحة التي كانت تذبح الأطفال في بلد المليون شهيد؟ بالتأكيد لم يأت هؤلاء جميعا من الفضاء.
سلّمنا مع الشاعر الفلسطيني محمود درويش بأن «الشر كله يأتي من أميركا»، في قصيدة صفق لها الكثيرون، ونسينا أن «دود الخل منو فيه». نعم، أميركا هي التي أتت بالجند والسلاح إلى العراق، وهي التي تعبث أياديها في الشأن الفلسطيني واللبناني. ولكن هل أميركا هي التي أتت أيضا بالبشر الذين يأكل بعضهم البعض في العراق ولبنان وفلسطين والسودان والجزائر والصومال؟ ذات البشر الذين ما زالوا يتغنون بأجدادهم المؤسسين للحضارات العريقة، هم لا أحد سواهم، الذين يتحفوننا اليوم بأبشع صور التناحر الهمجي بين أبناء الوطن الواحد، وننام ونصحو معهم على شبح حروب داخلية ستشعل المنطقة بأكملها.
في العراق، أميركا أخرجت المارد من قمقمه، لكنها لم تخترعه، المارد كان قابعا هناك ينتظر لحظة الانفلات. العراقيون كلما واجهتهم بالطائفية الدفينة التي تخيم على سمائهم كغيمة سوداء تمطر موتا، قالوا إن عراق بلاد الرافدين لم يعرف الطائفية الا بعد دخول الأميركيين. هل حقا ان العراقيين لم يسمعوا بالطائفية قبل الغزو الأميركي، وأنهم كانوا متصالحين مع تاريخهم، ومتجاوزين للمحن الدموية التي مروا بها؟ هل حقا ان إعلان الولاية في غدير خم ومشاورات السقيفة، الحدثين المفصليين في صدر الإسلام، قد أشبعا حوارا وفهما مشتركا بين طائفتي العراق الكبريين، وتم تجاوز ظلهما الثقيل، ليس على العراق فحسب، بل على المنطقة بأكملها؟ هل حقا ان الشيعة في العراق، والمنطقة عموما، ليست لديهم رغبة في تغيير مسار الدول والأيام باتجاه ما يرونه حقا لهم قد اغتصب؟ ألم يقل الخميني يوم انتصار ثورته: «عدت لأصحح التاريخ»؟
إن أصل المشكلة في العراق يكمن في الماضي. وهذه النزاعات التي اتخذت هيئة إشكاليات معقدة لم تحل، ظلت تنمو كفطريات وطفيليات تحت صخرة ديكتاتورية ألقى بها النظام السابق على صدر العراق، وعندما أزيحت هذه الصخرة انتشرت رائحة العفونة والرطوبة، وطفت على السطح ضغائن المذاهب التي يرى كل منها أنه يمتلك الحق والحقيقة. وهناك صخور كثيرة في المنطقة، إن تحركت ربما شممنا نفس العطن، وأطلت من تحتها رؤوس ذات الأفاعي.
الديكتاتوريات والأفكار الشمولية الكبرى تلون المجتمعات بلون قاتم أوحد، تخفي الاختلاف ولكنها لا تلغيه. وكلنا يعرف ما ظهر بعد انهيار الشيوعية من تناحر إثني في الدول التي كانت تنضوي تحت هذه الايديولوجية الكبيرة. أراد صدام حسين أن يغير الطبيعة السكانية ـ الجغراقية للعراق، بإجباره عراقيين عربا شيعة على العيش في الشمال الكردي، وبالمقابل تهجير بعض الشماليين إلى الجنوب المختلف عرقيا ومذهبيا. محاولة ساذجة لطاغية ساذج لإخفاء الاختلاف. وكان أول ما طالب به المهجرون من كلا الاتجاهين، بعد سقوط نظام صدام، العودة إلى أماكنهم الأصلية. لم يقف أحد في وجه صدام، لأن الديكتاتوريات أيضا تعلم مواطنيها الكذب ولي الحقائق والهروب من الواقع حتى لا يجدوا أنفسهم في مواجهة السلطة. العقل الديكتاتوري عقل ملفق وكاذب، وفضائياتنا نتاج مباشر لهذا العقل الكاذب. الحقيقة هي أن الأميركيين لم يختلقوا الدراما المعقدة التي تشكل البركان الكامن في ماضي العراق ومستقبله، ولم يختلقوا كذلك الضغائن والأحقاد والرغبة في إلغاء الآخر المختلف في بلادنا. هم فقط أزاحوا الصخرة، لم يتوقعوا حجم العفونة التي تنتظرهم تحتها، وهنا يكمن خطأهم الذي لا يغتفر. تغيظ المرء في لبنان مقولات مثل: «لبنان بلد صغير يتعايش فيه أكبر عدد من الطوائف»، أو: «لبنان بلد ديمقراطي». إذا كان الأمر كذلك (يا جماعة)، فلماذا لم نركم متعايشين منذ ما يسمى بالاستقلال؟ ولماذا تحتاجون في كل مرة لجولات دبلوماسية وشخصية وأمنية، وسفارات، ووصايات، ومؤتمرات مصغرة وموسعة، واتفاقات منفردة وثنائية وجماعية، وجيوش تدخل وجيوش تخرج؟ ولماذا ما دمتم رمز التعايش، لديكم بيروتان بدلا من بيروت واحدة، وتقطن الجبل الطائفة الفلانية، وتسكن الضاحية الطائفة العلانية، وكل في فلك يسبحون؟
الذين يبحثون اليوم عن مستقبل لبنان، معتصمون أمام السراي الحكومي، لإسقاط الحكومة، لهم كامل الحق في التعبير عن عدم رضاهم. ولكن لنفترض أن هذه الجموع أسقطت حكومة السنيورة، ترى ماذا ينتظر لبنان؟ إذا أراد اللبنانيون رؤية المستقبل فلينظروا جنوبا إلى حكومة «حماس» المحاصرة دوليا، وما يعانيه الفلسطينيون من مقاطعة المجتمع الدولي لها، حتى باتت رواتب الموظفين تدفع كحسنات من قبل بعض الدول العربية. وبدورها إذا أرادت «حماس» أن تعرف ما ينتظر الفلسطينيون في القريب العاجل، إذا ما أصرت على ابتعادها عن الممكن والمعقول، والنحو اتجاه التخوين وحشد الغضب والحقد بين أبناء الشعب الفلسطيني، فما عليها إلا أن تيمم وجهها شطر العراق، فهناك يكمن المستقبل.
المستقبل لا يأتي من الهواء. مستقبل المنطقة مرتبط بماضيها، وما لم تحل عقد الماضي، فإن حبل المستقبل لن يستقيم. مستقبلنا يأتي منا. البشر أيضا لا يأتون من الهواء، ولا على دبابات أميركية، فأبناء هذه المنطقة المتناحرون حتى الموت، هم منا.. ابن لادن والظواهري والزرقاوي منا. صدام حسين ومقتدى الصدر وحارث الضاري منا. المالكي وطالباني والحكيم وعلاوي منا. سعد الحريري وحسن نصر الله وميشيل عون والسنيورة منا. بيير الجميل وجبران تويني وسمير قصير منا. الترابي والغنوشي وبلحاج منا. اسماعيل هنية ومحمود عباس وخالد مشعل ومحمد دحلان منا. هؤلاء البشر منا. وهذا الماضي الذي يمسك بعنق الحاضر، منا. الأميركان قد تأتي منهم شرور كثيرة، لكن ليست تلك التي تنبع منا. الأميركان لم يخترعونا، هم فقط نزعوا عنا سدادة القمقم، وقمنا نحن أبناء هذه الحضارات القديمة والعظيمة بكل هذا القتل وكل هذا الدمار
Wednesday, March 5, 2008
بقايا ونفايات الحرب الباردة

مشهد المسلمين في كوسوفو وهم يرفعون العلم الأميركي مقابل مشهد المسيحيين الصرب وهم يحرقون العلم الأميركي، يوم أعلنت الولايات المتحدة دعمها لاستقلال كوسوفو، هو مشهد مثير للدهشة. الصرب المسيحيون لم يحرقوا العلم وحسب، بل حاولوا حرق السفارة الأميركية أيضا. وفي المقابل، كان الألبان المسلمون يطوفون الشوارع رافعين راية الأميركان (الكفار).
هذا المشهد لا يروق لمن يريدون تبسيط السياسة الدولية ويختصرونها بعداء أميركا المطلق للمسلمين في كل زمان ومكان، وبنظرية الصدام المحتم بين المسلمين كافة والمسيحيين عامة. الحقيقة هي أن السياسة الدولية تحكمها مصالح دول وسياسات عليا، قد يكون الدين عنصرا فاعلا فيها ولكنه ليس العنصر الوحيد. الدين في السياسة الدولية قد يستخدم كوسيلة دعاية، ولكن قلما أن يكون من المحركات الرئيسية للسياسة الدولية. دارسو العلاقات الدولية يعرفون أنه خلف الشعارات الدينية تقبع مصالح دنيوية ليست غالبا مثالية كما يدعي أصحابها. ففي حرب البلقان في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، وقفت أوروبا وأميركا ضد الصرب في أزمة البوسنة، قاتل الأوروبيون والأميركيون وقتها نيابة عن المسلمين.
ويكون من السذاجة أيضا أن نتصور بأن مجتمعا أغلبه مسيحي، كما الولايات المتحدة وأوروبا، سيقف «لوجه الله» مع المسلمين. الحقيقة أن أميركا كدولة مع حلفائها من الدول الأوروبية استخدمت قضية البوسنة خاصة، وأوروبا الشرقية بوجه عام، لتصفية ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي ونفوذه في القارة القديمة. موقف الولايات المتحدة وأوروبا من مسلمي البلقان اليوم هو أشبه بموقفهما البارحة مع المجاهدين الأفغان في حربهم مع الخصم ذاته في آسيا وهو الاتحاد السوفيتي.. معهم اليوم وقد ينقلبون عليهم غدا أو لا ينقلبون وفق مصالح الأميركان لا مصالح الألبان. هناك البعض ممن يمحون هذه التفاصيل من التاريخ من أجل تقديم صورة عالم يتصارع فيه المسلمون والمسيحيون. قد يكون الشرق الأوسط في إحدى صور صراعاته العديدة هو هذا العالم، ولكن ليس بالضرورة ما ينسحب على الشرق الأوسط ينسحب على بقاع الأرض كلها. وقد يتوارد إلى ذهن البعض أن الحروب الصليبية، أو حتى الفتوحات الإسلامية، هي أوضح صور الصراع الديني. صحيح، ولكن يجب ألا يغفل عن أذهاننا بأن أحد الفوارق المهمة بين الحروب الصليبية والفتوحات الإسلامية وبين حروب اليوم، هو أن عالم الدول في هذا الزمن يختلف عن عالم التكوينات العملاقة (الإمبراطوريات) التي جرت في زمنها هذه الحروب، وأن معاهدة ويستفاليا عام 1648 التي أنهت الحروب الدينية بين الإمبراطوريات الكبرى، الإمبراطورية الرومانية والفرنسية وحلفائهما، كانت الحدث الفارق بين ظهور الدولة الحديثة والإمبراطوريات القديمة، ولكل خصائصه. العلاقات الدولية، كما نعرفها اليوم، هي عالم ما بعد ويستفاليا وليس قبلها.
إذن في ضوء ما سبق، هل بالإمكان أن نتوقع في المدى المنظور مشهدا مماثلا في الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، أي أن نرى الفلسطينيين يرفعون العلم الأميركي بينما الإسرائيليون يحرقونه؟ هذا المشهد ليس من المتوقع أن يحدث قريبا بالطبع. لكن فكرة أنه لن يحدث أبدا، ولا يمكن أن يحدث في أي زمان أو مكان، بالطريقة التي يتحدث بها البعض، هو نوع من التشاؤم المفرط وتغليب عالم المشاعر والعواطف على عالم المصالح والمنطق الحاكم لعلاقات الدول. قد تأتي لحظة تتناقض فيها المصالح الأميركية والإسرائيلية بما يخدم مصلحة الفلسطينيين، وهذا وارد جدا في العلاقات الدولية. والحقيقة أن أحد أسباب غياب أي تناقض بين المصالح الأميركية والإسرائيلية هو إصرار العرب لزمن طويل على الابتعاد عن الولايات المتحدة بافتراض أنها عدو مطلق ومستمر وثابت، بغض النظر عن إصرار إسرائيل في الوقت نفسه على التقرب من الدولة الكبرى.
المنطقي أن تكون مصالح الولايات المتحدة مع الدول العربية مجتمعة، بما فيها من موارد طبيعية وبشرية وطاقة نفطية وغاز، أكبر مئات المرات من مصالحها مع دولة صغيرة بحجم إسرائيل قليلة السكان والموارد والمنافذ. ولكن إسرائيل، التي تعلن، على عكس العرب، بأنها حليفة وصديقة للولايات المتحدة تجعل الأميركيين، حكومة وشعبا، مقتنعين تماما بأن إسرائيل هي حليفهم الوحيد في المنطقة، وأن مصلحة إسرائيل هي مصلحتهم وبالتالي أي خطر يتهددها هو خطر على أميركا.
حديث العرب عن أميركا بمعظمه هو حديث كراهية. وقد تكون مصر هي المثال الأوضح هنا. في مصر حملة كراهية لأميركا تقودها قطاعات كبيرة في المجتمع المصري، ولو قرأنا المشهد المصري بحيادية في هذه الحالة الخاصة أي (العلاقة الأميركية ـ المصرية على المستويين الحكومي والشعبي) لبدا الأمر عجيبا. بداية، ليست هناك حدود تستوجب صراعا كما ليست هناك معارك سابقة بين مصر وأميركا. ومصر هي ثاني أكبر متلق للمعونة الأميركية. ومصر تجري مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة بشكل دوري. وفي العاصمة المصرية القاهرة توجد أكبر سفارة للولايات المتحدة في الشرق بعد العراق، مما يعكس كبر حجم المصالح بين الدولتين. فإذا كانت كل هذه المؤشرات الإيجابية وكل هذا التعاون بين البلدين، فمن أين أتت الكراهية؟ الرد الجاهز هو أن المصريين بتعاطفهم مع العراقيين والفلسطينيين كرهوا الأميركيين (في السكة)!
وطبعا عداء دولة كبرى بحجم الولايات المتحدة يرضي الغرور، على مبدأ «إذا سرقت اسرق جملا، وإن عشقت اعشق قمرا»، وإن عاديت عادي الأميركان. فالبعض يريد عدوا عظيما يليق به! فلا يمكن أن يعادي نيكاراغوا مثلا، أو خصوم الداخل الصغار، اللعب مع الصغار يقلل من الهيبة. فالبعض «يحب العالي ولو على خازوق»، كما يقول المثل. وما ينسحب على مصر ينسحب على كثير من الدول العربية. نحن نريد أن نلعن أميركا كل يوم، وعلى أميركا أن تتحالف مع مصالحنا وهي صاغرة.
علاقة الولايات المتحدة بالعراق في ثمانينات القرن الماضي، كانت توحي بأن أميركا ستكون في صف العراق إذا ما دخل في أية خصومة. وهذا كان موقف الولايات المتحدة فعلا في الحرب العراقية ـ الإيرانية التي امتدت لثماني سنوات. وكانت علاقة أميركا بالعراق أقوى بكثير من علاقتها بالكويت، فالعراق دولة أكبر وأغنى من الكويت، ولكن عندما تجاوز صدام حسين الخطوط الحمراء للمصالح الأميركية في المنطقة بغزوه الكويت في أغسطس 1990، تغيرت الحسابات الأميركية تماما لدرجة توجيه ضربة عسكرية أميركية قوية ضد حليف الأمس، ضربة أخرجته من أرض الكويت، ثم بعد ثلاثة عشر عاما ضربة أخرى أخرجته من الدنيا بأكملها.
لو كانت الولايات المتحدة تتعاطى مع الدول الأخرى باعتبارها حليفة دائمة أو عدوة دائمة، لكانت أيدت غزو صدام للكويت باعتباره حليفها السابق. وخصوصا أنه لم يكن يوجد «لوبي» كويتي قوي يضغط على الحكومة الأميركية وقتئذ. إلا أن الأميركان وقفوا مع الكويت ضد عراق صدام، ورأينا مشهدا شبيها بما نراه في كوسوفو وصربيا اليوم.. الكويتيون رفعوا العلم الأميركي بينما كان العراقيون يحرقونه.
قد تبدو حروب أميركا في العراق وأفغانستان والبلقان غير مفهومة حيث لا يوجد بينها رابط مفهوم، لكن الناظر إلى الأمور ضمن منظور استراتيجي يرى أن حروب وتحالفات الولايات المتحدة في هذه الفترة الانتقالية للنظام الدولي من الثنائية القطبية إلى نظام أحادي القطبية، هي حروب بقصد لملمة وتنظيف بقايا ونفايات الحرب الباردة.. حسابات لا يدخل، بكل تأكيد، الدين فيها